ثمراتُ الرِّضا اليانعة (1)
عائض بن عبد الله القرني
رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ: وللرضا ثمراتٌ إيمانيةٌ كثيرةٌ وافرةٌ تنتجُ عنه، يرتفعُ بها الراضي إلى أعلى المنازلِ، فيُصبحُ راسخاً في يقيِنه، ثابتاً في اعتقادِه، وصادقاً في أقوالِه وأعمالِه وأحوالِه.
فتمامُ عبوديِّتِه في جَرَيانِ ما يكرهُهُ من الأحكام عليه. ولو لم يجْرِ عليه منها إلاَّ ما يحبُّ، لكان أبْعَد شيءٍ عنْ عبوديَّة ربِّه، فلا تتمُّ له عبوديَّة. من الصَّبرِ والتَّوكلِ والرِّضا والتضرُّعِ والافتقارِ والذُّلِّ والخضوعِ وغَيْرِها – إلاَّ بجريانِ القدرِ له بما يكرهُ، وليس الشأنُ في الرضا بالقضاءِ الملائم للطبيعةِ، إنما الشأنُ في القضاءِ المُؤْلِمِ المنافِرِ للطَّبْعِ. فليس للعبدِ أنْ يتحكَّم في قضاءِ اللهِ وقدرِه، فيرضى بما شاء ويرفضُ ما شاء، فإنَّ البشر ما كان لهمِ الخِيَرَةُ، بلْ الخيرةُ اللهِ، فهو أعْلمُ وأحْكمُ وأجلُّ وأعلى، لأنه عالمُ الغيبِ المطَّلِعُ على السرائرِ، العالمُ بالعواقبِ المحيطُ بها.
رضاً برضا: ولْيَعْلم أنَّ رضاه عن ربِّه سبحانهُ وتعالى في جميعِ الحالاتِ، يُثمِرُ رضا ربُه عنه، فإذا رضي عنه بالقليلِ من الرِّزقِ، رضي ربُّه عنه بالقليلِ من العملِ، وإذا رضي عنه في جميع الحالاتِ، واستوتْ عندهُ، وجدهُ أسْرَعَ شيءٍ إلى رضاهُ إذا ترضَّاه وتملَّقه؛ ولذلك انظرْ للمُخلصيِن مع قِلَّةِ عملهِم، كيف رضي اللهُ سعيهم لأنهمْ رضُوا عنهُ ورضي عنهمْ، بخلافِ المنافقين، فإنَّ الله ردَّ عملهم قليلهُ وكثيرهُ؛ لأنهمِ سخِطُوا ما أنزلَ الله وكرهُوا رضوانهُ، فأحبط أعمالهم.
منْ سخِط فلهُ السُّخْطُ : والسُّخطُ بابُ الهمِّ والغمِّ والحزنِ، وشتاتِ القلبِ، وكسفِ البالِ، وسُوءِ الحالِ، والظَّنِّ بالله خلافُ ما هو أهلُه. والرضا يُخلِّصُه منْ ذلك كلِّه، ويفتحُ له باب جنةِ الدنيا قبل الآخرةِ، فإنَّ الارتياح النفسيَّ لا يتمُّ بمُعاكسةِ الأقدارِ ومضادَّة القضاءِ، بل بالتسليمِ والإذعانِ والقبُولِ، لأنَّ مدبِّر الأمرِ حكيمٌ لا يُتَّهمُ في قضائِه وقدرهِ، ولا زلتُ أذكرُ قصة ابن الراونديِّ الفيلسوف الذَّكّيِ الملحدِ، وكان فقيراً، فرأى عاميّاً جاهلاً مع الدُّورِ والقصورِ والأموالِ الطائلةِ، فنظر إلى السماءِ وقال: أنا فيلسوفُ الدنيا وأعيشُ فقيراً، وهذا بليدٌ جاهلٌ ويحيا غنيّاً، وهذه قِسمةٌ ضِيزى. فما زادهُ اللهُ إلا مقْتاً وذُلاّ وضنْكاً {وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ}(فصلت:16).
فوائدُ الرِّضا: فالرِّضا يُوجِبُ له الطُّمأنينة، وبرد القلبِ، وسكونهُ وقراره وثباتهُ عند اضطرابِ الشُّبهِ والتباسِ والقضايا وكثْرةِ الواردِ، فيثقُ هذا القلبُ بموعودِ اللهِ وموعودِ رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولُ لسانُ الحالِ: {هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً}(الأحزاب:22). والسخطُ يوجبُ اضطراب قلبِه، وريبتهُ وانزعاجهُ، وعَدَمَ قرارِهِ، ومرضهُ وتمزُّقهُ، فيبقى قلِقاً ناقِماً ساخِطاً متمرِّداً، فلسانُ حالِه يقولُ: {مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً}(الأحزاب:12).
فأصحابُ هذه القلوبِ إن يكُن لهمُ الحقُّ، يأتوا إليه مُذعِنِين، وإن طُولِبوا بالحقِّ إذا همْ يصْدفِون، وإنْ أصابهم خيرٌ اطمأنٌّوا به، وإنْ أصابتهم فتنةٌ انقلبُوا على وجوههِم، خسرُوا الدنيا والآخرةِ {ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ}(الحج:11).
كما أنّ الرضا يُنزلُ عليه السكينة التي لا أَنْفَعَ له منها، ومتى نزلتْ عليه السكينةُ، استقام وصلحتْ أحوالُه، وصلح بالُه، والسُّخط يُبعِدُه منها بحسبِ قلَّتِه وكثرتِه، وإذا ترحَّلتْ عنهُ السكينةُ، ترحَّل عنه السرورُ والأمْنُ والراحةُ وطِيبُ العيشِ. فمنْ أعْظَمِ نعمِ اللهِ على عبدِه: تنزُّلُ السكينةِ عليهِ. ومنْ أعظمِ أسبابِها: الرضا عنه في جميعِ الحالاتِ.
لا تُخاصِم ربَّك : والرضا يخلِّصُ العبد منْ مُخاصمةِ الربِّ تعالى في أحكامِه وأقضيتِه. فإنَّ السُّخط عليهِ مُخاصمةٌ له فيما لم يرض به العبدُ، وأصلُ مخاصمةِ إبليس لربِّه: منْ عَدَمِ رضاه بأقْضِيَتِه، وأحكامِه الدِّينيِة والكونيِة.
وإنَّما ألحد منْ ألحدَ، وجَحِدَ منْ جحد لأنهُ نازعَ ربَّه رداء العظمةِ وإزار الكبرياءِ، ولم يُذعِنْ لمقامِ الجبروتِ، فهو يُعطِّلُ الأوامر، وينتهِكُ المناهي، ويتسخَّطُ المقادير، ولم يُذعِنْ للقضاءِ.
حُكْمٌ ماضٍ وقضاءٌ عَدْلٌ : وحُكمُ الرَّبِّ ماضٍ في عبدِه، وقضاؤُه عدْلٌ فيه، كما في الحديثِ: «ماضٍ فيَّ حكمُك ، عَدْلٌ في قضاؤك» صحيح ابن حبان .
ومنْ لم يرض بالعدلِ، فهو منْ أهلِ الظُّلمِ والجوْرِ. واللهُ أحكمُ الحاكمين، وقدْ حرَّ الظلُّمَ على نفسِه، وليس بظلاَّمٍ للعبيدِ، وتقدَّس سبحانه وتنزَّه عنْ ظُلْمِ الناسِ، ولكنّ أنْفُسهم يظلمون.
وقولُه : «عَدْلٌ في قضاؤك» يَعُمُّ قضاء الذنبِ، وقضاء أثرِهِ وعقوبتِه، فإنَّ الأمرينِ منْ قضائِه عزَّ وجلَّ، وهو أعدلُ العادلين في قضائِه بالذنبِ، وفي قضائِه بعقوبتِه.
وقد يقضي سبحانه بالذنبِ على العبدِ لأسرارٍ وخفايا هو أعْلَمُ بها، قد يكونُ لها من المصالحِ العظيمِة ما لا يعلمُها إلا هُو.
لا فائدة في السُّخطِ : وعدمُ الرَّضا: إمَّا أنْ يكون لفواتِ ما أخطأهُ ممَّ يحبُّه ويريدهُ، وإمّا لإصابةٍ بما يكرهُه ويُسخطُه. فإذا تيقَّن أنَّ ما أخطأه لم يكُنْ ليُصيبَه، وما أصابه لم يكنْ ليُخطئه، فلا فائدة في سخطِه بعد ذلك إلا فواتُ ما ينفعُه، وحصولُ ما يضرُّه.
وفي الحديث: « يا أبا هريرة جفَّ القلمُ بما أنت لاقٍ» إسناده صحيح.
السلامةُ مع الرِّضا : والرضا يفتحُ له باب السلامةِ، فيجعلُ قلبهُ سليماً، نقيّاً من الغشِّ والدَّغلِ والغلِّ، ولا ينجو منْ عذابِ اللهِ إلا منْ أتى الله بقلبٍ سليمٍ، وهو السَّالِمُ من الشُّبهِ، والشَّكِّ والشِّركِ، وتلبُّسِ إبليس وجُندِه، وتخذيلِهِ وتسويفِهِ، ووعْدِه ووعيدِه، فهذا القلبُ ليس فيهِ إلا اللهُ: {قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ}(الأنعام:91).
وكذلك تستحيلُ سلامةُ القلبِ من السُّخطِ وعدمِ الرضا، وكلَّما كان العبدُ أشدَّ رضاً، كان قلبُه أسْلَمَ. فالخبثُ والدَّغَلُ والغشُّ: قرينُ السُّخطِ. وسلامةُ القلبِ وبرُّه ونُصحُه: قرينُ الرضا. وكذلك الحسدُ هو منْ ثمراتِ السخطِ. وسلامةُ القلبِ منهُ: منْ ثمراتِ الرضا.
فالرضا شجرةٌ طيِّبة، تُسقى بماءِ الإخلاصِ في بستانِ التوحيدِ، أصلُها الإيمانُ، وأغصانُها الأعمالُ الصالحةُ، ولها ثمرةٌ يانِعةٌ حلاوتُها. في الحديثِ: «ذاق طعْم الإيمانِ منْ رضي باللهِ ربّاً، وبالإسلام ديِناً، وبحمدٍ نبياً»حسن صحيح. وفي الحديث أيضاً: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسولُهُ أَحَبَّ إليه مما سِوَاهما، و أن ويُحِبَّ المرء لا يُحِبُّهُ إلا لله، وأن يَكْرَهَ أن يعود في الكفر، بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يُقْذَفَ في النار»صحيح مسلم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات
عائض بن عبد الله القرني
رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ: وللرضا ثمراتٌ إيمانيةٌ كثيرةٌ وافرةٌ تنتجُ عنه، يرتفعُ بها الراضي إلى أعلى المنازلِ، فيُصبحُ راسخاً في يقيِنه، ثابتاً في اعتقادِه، وصادقاً في أقوالِه وأعمالِه وأحوالِه.
فتمامُ عبوديِّتِه في جَرَيانِ ما يكرهُهُ من الأحكام عليه. ولو لم يجْرِ عليه منها إلاَّ ما يحبُّ، لكان أبْعَد شيءٍ عنْ عبوديَّة ربِّه، فلا تتمُّ له عبوديَّة. من الصَّبرِ والتَّوكلِ والرِّضا والتضرُّعِ والافتقارِ والذُّلِّ والخضوعِ وغَيْرِها – إلاَّ بجريانِ القدرِ له بما يكرهُ، وليس الشأنُ في الرضا بالقضاءِ الملائم للطبيعةِ، إنما الشأنُ في القضاءِ المُؤْلِمِ المنافِرِ للطَّبْعِ. فليس للعبدِ أنْ يتحكَّم في قضاءِ اللهِ وقدرِه، فيرضى بما شاء ويرفضُ ما شاء، فإنَّ البشر ما كان لهمِ الخِيَرَةُ، بلْ الخيرةُ اللهِ، فهو أعْلمُ وأحْكمُ وأجلُّ وأعلى، لأنه عالمُ الغيبِ المطَّلِعُ على السرائرِ، العالمُ بالعواقبِ المحيطُ بها.
رضاً برضا: ولْيَعْلم أنَّ رضاه عن ربِّه سبحانهُ وتعالى في جميعِ الحالاتِ، يُثمِرُ رضا ربُه عنه، فإذا رضي عنه بالقليلِ من الرِّزقِ، رضي ربُّه عنه بالقليلِ من العملِ، وإذا رضي عنه في جميع الحالاتِ، واستوتْ عندهُ، وجدهُ أسْرَعَ شيءٍ إلى رضاهُ إذا ترضَّاه وتملَّقه؛ ولذلك انظرْ للمُخلصيِن مع قِلَّةِ عملهِم، كيف رضي اللهُ سعيهم لأنهمْ رضُوا عنهُ ورضي عنهمْ، بخلافِ المنافقين، فإنَّ الله ردَّ عملهم قليلهُ وكثيرهُ؛ لأنهمِ سخِطُوا ما أنزلَ الله وكرهُوا رضوانهُ، فأحبط أعمالهم.
منْ سخِط فلهُ السُّخْطُ : والسُّخطُ بابُ الهمِّ والغمِّ والحزنِ، وشتاتِ القلبِ، وكسفِ البالِ، وسُوءِ الحالِ، والظَّنِّ بالله خلافُ ما هو أهلُه. والرضا يُخلِّصُه منْ ذلك كلِّه، ويفتحُ له باب جنةِ الدنيا قبل الآخرةِ، فإنَّ الارتياح النفسيَّ لا يتمُّ بمُعاكسةِ الأقدارِ ومضادَّة القضاءِ، بل بالتسليمِ والإذعانِ والقبُولِ، لأنَّ مدبِّر الأمرِ حكيمٌ لا يُتَّهمُ في قضائِه وقدرهِ، ولا زلتُ أذكرُ قصة ابن الراونديِّ الفيلسوف الذَّكّيِ الملحدِ، وكان فقيراً، فرأى عاميّاً جاهلاً مع الدُّورِ والقصورِ والأموالِ الطائلةِ، فنظر إلى السماءِ وقال: أنا فيلسوفُ الدنيا وأعيشُ فقيراً، وهذا بليدٌ جاهلٌ ويحيا غنيّاً، وهذه قِسمةٌ ضِيزى. فما زادهُ اللهُ إلا مقْتاً وذُلاّ وضنْكاً {وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ}(فصلت:16).
فوائدُ الرِّضا: فالرِّضا يُوجِبُ له الطُّمأنينة، وبرد القلبِ، وسكونهُ وقراره وثباتهُ عند اضطرابِ الشُّبهِ والتباسِ والقضايا وكثْرةِ الواردِ، فيثقُ هذا القلبُ بموعودِ اللهِ وموعودِ رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولُ لسانُ الحالِ: {هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً}(الأحزاب:22). والسخطُ يوجبُ اضطراب قلبِه، وريبتهُ وانزعاجهُ، وعَدَمَ قرارِهِ، ومرضهُ وتمزُّقهُ، فيبقى قلِقاً ناقِماً ساخِطاً متمرِّداً، فلسانُ حالِه يقولُ: {مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً}(الأحزاب:12).
فأصحابُ هذه القلوبِ إن يكُن لهمُ الحقُّ، يأتوا إليه مُذعِنِين، وإن طُولِبوا بالحقِّ إذا همْ يصْدفِون، وإنْ أصابهم خيرٌ اطمأنٌّوا به، وإنْ أصابتهم فتنةٌ انقلبُوا على وجوههِم، خسرُوا الدنيا والآخرةِ {ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ}(الحج:11).
كما أنّ الرضا يُنزلُ عليه السكينة التي لا أَنْفَعَ له منها، ومتى نزلتْ عليه السكينةُ، استقام وصلحتْ أحوالُه، وصلح بالُه، والسُّخط يُبعِدُه منها بحسبِ قلَّتِه وكثرتِه، وإذا ترحَّلتْ عنهُ السكينةُ، ترحَّل عنه السرورُ والأمْنُ والراحةُ وطِيبُ العيشِ. فمنْ أعْظَمِ نعمِ اللهِ على عبدِه: تنزُّلُ السكينةِ عليهِ. ومنْ أعظمِ أسبابِها: الرضا عنه في جميعِ الحالاتِ.
لا تُخاصِم ربَّك : والرضا يخلِّصُ العبد منْ مُخاصمةِ الربِّ تعالى في أحكامِه وأقضيتِه. فإنَّ السُّخط عليهِ مُخاصمةٌ له فيما لم يرض به العبدُ، وأصلُ مخاصمةِ إبليس لربِّه: منْ عَدَمِ رضاه بأقْضِيَتِه، وأحكامِه الدِّينيِة والكونيِة.
وإنَّما ألحد منْ ألحدَ، وجَحِدَ منْ جحد لأنهُ نازعَ ربَّه رداء العظمةِ وإزار الكبرياءِ، ولم يُذعِنْ لمقامِ الجبروتِ، فهو يُعطِّلُ الأوامر، وينتهِكُ المناهي، ويتسخَّطُ المقادير، ولم يُذعِنْ للقضاءِ.
حُكْمٌ ماضٍ وقضاءٌ عَدْلٌ : وحُكمُ الرَّبِّ ماضٍ في عبدِه، وقضاؤُه عدْلٌ فيه، كما في الحديثِ: «ماضٍ فيَّ حكمُك ، عَدْلٌ في قضاؤك» صحيح ابن حبان .
ومنْ لم يرض بالعدلِ، فهو منْ أهلِ الظُّلمِ والجوْرِ. واللهُ أحكمُ الحاكمين، وقدْ حرَّ الظلُّمَ على نفسِه، وليس بظلاَّمٍ للعبيدِ، وتقدَّس سبحانه وتنزَّه عنْ ظُلْمِ الناسِ، ولكنّ أنْفُسهم يظلمون.
وقولُه : «عَدْلٌ في قضاؤك» يَعُمُّ قضاء الذنبِ، وقضاء أثرِهِ وعقوبتِه، فإنَّ الأمرينِ منْ قضائِه عزَّ وجلَّ، وهو أعدلُ العادلين في قضائِه بالذنبِ، وفي قضائِه بعقوبتِه.
وقد يقضي سبحانه بالذنبِ على العبدِ لأسرارٍ وخفايا هو أعْلَمُ بها، قد يكونُ لها من المصالحِ العظيمِة ما لا يعلمُها إلا هُو.
لا فائدة في السُّخطِ : وعدمُ الرَّضا: إمَّا أنْ يكون لفواتِ ما أخطأهُ ممَّ يحبُّه ويريدهُ، وإمّا لإصابةٍ بما يكرهُه ويُسخطُه. فإذا تيقَّن أنَّ ما أخطأه لم يكُنْ ليُصيبَه، وما أصابه لم يكنْ ليُخطئه، فلا فائدة في سخطِه بعد ذلك إلا فواتُ ما ينفعُه، وحصولُ ما يضرُّه.
وفي الحديث: « يا أبا هريرة جفَّ القلمُ بما أنت لاقٍ» إسناده صحيح.
السلامةُ مع الرِّضا : والرضا يفتحُ له باب السلامةِ، فيجعلُ قلبهُ سليماً، نقيّاً من الغشِّ والدَّغلِ والغلِّ، ولا ينجو منْ عذابِ اللهِ إلا منْ أتى الله بقلبٍ سليمٍ، وهو السَّالِمُ من الشُّبهِ، والشَّكِّ والشِّركِ، وتلبُّسِ إبليس وجُندِه، وتخذيلِهِ وتسويفِهِ، ووعْدِه ووعيدِه، فهذا القلبُ ليس فيهِ إلا اللهُ: {قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ}(الأنعام:91).
وكذلك تستحيلُ سلامةُ القلبِ من السُّخطِ وعدمِ الرضا، وكلَّما كان العبدُ أشدَّ رضاً، كان قلبُه أسْلَمَ. فالخبثُ والدَّغَلُ والغشُّ: قرينُ السُّخطِ. وسلامةُ القلبِ وبرُّه ونُصحُه: قرينُ الرضا. وكذلك الحسدُ هو منْ ثمراتِ السخطِ. وسلامةُ القلبِ منهُ: منْ ثمراتِ الرضا.
فالرضا شجرةٌ طيِّبة، تُسقى بماءِ الإخلاصِ في بستانِ التوحيدِ، أصلُها الإيمانُ، وأغصانُها الأعمالُ الصالحةُ، ولها ثمرةٌ يانِعةٌ حلاوتُها. في الحديثِ: «ذاق طعْم الإيمانِ منْ رضي باللهِ ربّاً، وبالإسلام ديِناً، وبحمدٍ نبياً»حسن صحيح. وفي الحديث أيضاً: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسولُهُ أَحَبَّ إليه مما سِوَاهما، و أن ويُحِبَّ المرء لا يُحِبُّهُ إلا لله، وأن يَكْرَهَ أن يعود في الكفر، بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يُقْذَفَ في النار»صحيح مسلم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات

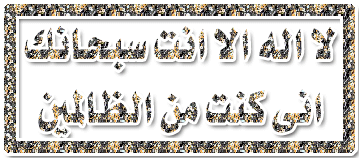
تعليق