تفسير الشيخ الشعراوي
(رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً )٢٥-الإسراء
إن المؤمن منطقيّ مع نفسه؛ لأنه آمن بقلبه ولسانه، وأن الكافر كذلك منطقيّ لأنه كفر بقلبه ولسانه، أما المنافق فغير منطقيّ مع نفسه؛ لأنه آمن بلسانه وجحد بقلبه.
وهذه الآية تدعونا إلى الحديث عن النفاق؛ لأنه ظاهرة من الظواهر المصاحبة للإيمان بالله، وكما نعلم فإن النفاق لم يظهر في مكة التي صادمتْ الإسلام وعاندته، وضيقتْ عليه، بل ظهر في المدينة التي احتضنتْ الدين، وانساحت به في شتى بقاع الأرض، وقد يتساءل البعض: كيف ذلك؟
نقول: النفاق ظاهرة صحية إلى جانب الإيمان؛ لأنه لا يُنافَق إلا القوي، والإسلام في مكة كان ضعيفاً، فكان الكفار يُجابهونه ولا ينافقونه، فلما تحوّل إلى المدينة اشتد عوده، وقويتْ شوكته وبدأ ضِعَاف النفوس ينافقون المؤمنين.
لذلك يقول أحدهم: كيف وقد ذَمَّ الله أهل المدينة، وقال عنهم: { وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ .. } [التوبة: 101].
نقول: لقد مدح القرآن أهل المدينة بما لا مزيدَ عليه، فقال تعالى في حقهم: { وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُوا ٱلدَّارَ وَٱلإِيمَانَ .. } [الحشر: 9].
وكأنه جعل الإيمان مَحَلاً للنازلين فيه. { يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .. } [الحشر: 9].
فإنْ قال بعد ذلك: { وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ .. } [التوبة: 101].
فالنفاق في المدينة ظاهرة صحية للإيمان؛ لأن الإيمان لو لم يكن قوياً في المدينة لما نافقه المنافقون.
ومن هنا جعل الله المنافقين في الدرْكِ الأسفل من النار، لأنه مُندَسٌّ بين المؤمنين كواحد منهم، يعايشهم ويعرف أسرارهم، ولا يستطيعون الاحتياط له، فهو عدو من الداخل يصعُب تمييزه. على خلاف الكافر، فعداوته واضحة ظاهرة معلنة، فيمكن الاحتياط له وأخذ الحذر منه.
ولكن لماذا الحديث عن النفاق ونحن بصدد الحديث عن عبادة الله وحده وبِرِّ الوالدين؟
الحق سبحانه وتعالى أراد أنْ يُعطينا إشارة دقيقة إلى أن النفاق كما يكون في الإيمان بالله، يكون كذلك في برِّ الوالدين، فنرى من الأبناء مَنْ يبرّ أبويْه نفاقاً وسُمْعة ورياءً، لا إخلاصاً لهما، أو اعترافاً بفضلهما، أو حِرْصاً عليهما.
ولهؤلاء يقول تعالى: { رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ .. } [الإسراء: 25].
لأن من الأبناء مَنْ يبرّ أبويه، وهو يدعو الله في نفسه أنْ يُريحه منهما، فجاء الخطاب بصيغة الجمع: { رَّبُّكُمْ } أي: رب الابن، وربّ الأبوين؛ لأن مصلحتكم عندي سواء، وكما ندافع عن الأب ندافع أيضاً عن الابن، حتى لا يقعَ فيما لا تُحمد عُقباه.
وقوله: { إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ .. } [الإسراء: 25].
أيْ: إن توفّر فيكم شَرْط الصلاح، فسوف يُجازيكم عليه الجزاء الأوفى. وإنْ كان غَيْر ذلك وكنتم في أنفسكم غير صالحين غَيْر مخلصين، فارجعوا من قريب، ولا تستمروا في عدم الصلاح، بل عودوا إلى الله وتوبوا إليه.
{ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً } [الإسراء: 25].
والأوابون هم الذين اعترفوا بذنوبهم ورجعوا تائبين إلى ربهم.
وقد سبق أنْ أوضحنا أن مشروعية التوبة من الله للمذنبين رحمةٌ من الخالق بالخلق؛ لأن العبد إذا ارتكب سيئة في غفلة من دينه أو ضميره، ولم تشرع لها توبة لوجدنا هذه السيئة الواحدة تطارده، ويشقى بها طِوَال حياته، بل وتدعوه إلى سيئة أخرى، وهكذا يشقى به المجتمع.
لذلك شرع الخالقُ سبحانه التوبة ليحفظ سلامة المجتمع وأَمْنه، وليُثرِي جوانب الخير فيه.

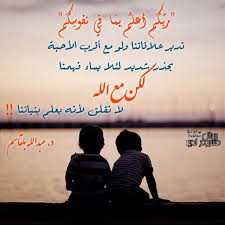
تأملات قرآنية ودلالات تربوية في كلمة (أوَّاب)
ن المتأمل في بديع وصف القرآن، وإيحاءاته التربوية في بناء النفس والحياة؛ يستوقفه روعة الأسلوب القرآني في ذلك، إذ يأتلف الأسلوب البليغ مع الإيحاء التربوي البديع، وهذا من خصائصه الفريدة، التي يتفرد بها البيان القرآني دون غيره من سائر البيان.
وفي هذا المقال نتناول دلالة كلمة (أواب) وإيحاءاتها التربوية في سياقات البيان القرآني المختلفة؛ ليتصف بها الدعاة والمربون في واقع الدعوة والحياة.
أولا- أوَّاب ( الاشتقاق اللغوي ودلالة الإيحاء )
إن كلمة أوَّاب هي صيغة مبالغة من الفعل آب فهو أوَّاب ، بمعنى راجع ، أي: كثير الأوبة والتوبة والرجوع إلى ربه ، وكل صيغ المبالغة هي في القرآن تفيد الكثرة البالغة والامتلاء بالوصف .
والبيان القرآني دقيق في اختيار أوّاب من الإياب دون غيرها كالرجوع مثلا ؛ لأن الإياب كما يرى الراغب الأصفهاني يكون من ذوي الإرادات، في حين أن الرجوع يكون منها ومن غيرها، فإننا نقول رجع المطر ، ورجع الحجر على صاحبه مثلا، ولا نقول في هذا المقام آب، فالجمادات لا يصدق عليها ذلك إذ لا إرادة لها.
ومن معانيه أيضا السير في النهار، فالتأويب هو السير في النهار،ومن معانيه أيضا السرعة، فناقة أواب، أي: سريعة، ومن معانيه السياقية أيضا التسبيح ومنه قوله تعالى عن نبيه داود (يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيد) [سبأ: 10] فالتأويب هنا هو التسبيح بدليل التصريح به في موضع آخر في وصف نبيه داود في قوله تعالى {إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاق}[ص: 18]، والتسبيح ضرب من ضروب التنزيه والتقديس والتعظيم لله عز وجل.
وتوحي صيغة أوَّاب (فعَّال) بالكثرة والقوة أيضا، أي: كثرة الرجوع وقوته ،فهو رجوع متكرروبقوة، مقرون برغبة وإرادة واعية مدركة .
ومن هنا يمكننا فهم دلالات إيحاء الصيغة في هذا المقام، بأن المؤمن بربه المحب له أوَّاب إليه،أي: كثير الرجوع إلى طاعته كلما شرد أو ابتعد أو ضعف في هذه الحياة، بموجب مركب النقص البشري فيه، تذكر فسارع بالرجوع إلى الطاعة والتوبة والأوبة. على سبيل الهيبة والتعظيم لربه، و بدافعية ذاتية، وبقوة وسرعة، وإرادة واعية ، كمن يسير في ضوء النهار، فهي أوبة ذاتية سريعة مشوبة بالتعظيم ، و متكررة بقوة وبوعي .
ثانيا :- مقامات (أوَّاب) في القرآن
وردت هذه الصفة في سياق المدح لثلاثة أنبياء في القرآن الكريم هم : داود وسليمان وأيوب عليهم السلام، وكذلك وردت عموما في وصف المؤمنين .
ولنا أن نتأمل هذه المقامات في سياقاتها المختلفة ؛ لاستخراج الفوائد والعبر من ذلك؛ للتحلي بهذه الصفة في حياة المؤمنين الدعاة .
نبي الله داود قوة الإيمان والسلطان.
ورد وصفه بهذه الصفة في قوله تعالى : {اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّاب}[ص: 17]
فجاء ذلك في سياق التثبيت بالصبر للنبي محمد ﷺ أن يتأسى بنبي الله داود، فقد وصفه الله بالعبودية والقوة وأنه أواب، فترتب على عبوديته وقوة إيمانه أن تأكد فيه وصف أواب أي: كثير الرجوع والإنابة والتوبة إلى ربه، فعلى المربين والدعاة المؤمنين التحلي بهذا الوصف ليستطيعوا الصبر والتحمل لمشاق الدعوة التي هي رسالة الأنبياء عليهم السلام، فلن يستطيعوا الصبر مالم تتحقق فيهم العبودية لله وقوة الإيمان التي تؤهلهم لأن يكونوا أوابين لله مخبتين له .
ونبي الله داود آتاه الله الملك ولم يشغله ذلك أو يصرفه عن الإنابة إليه، فهذا أنموذج إيماني رفيع في الجمع بين الملك والعبودية والإنابة.
فعلى الدعاة إلى الله الإمساك بزمام المبادرة في قيادة الحياة، ولا يصرفهم ذلك أو يشغلهم عن الله، إنما هم قادة أوَّابون إليه ، يستمدون العون منه والتوفيق والقوة والثبات.
نبي الله سليمان، الشاكر الأواب:
وقد مدحه الله عز وجل بالعبودية الحقة وأنه أواب ، فقال : { وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب} [ص: 30] وعلل وصفه إياه بأواب؛ أنه ابتلي بأمر من أمور الدنيا شغله عن ذكر ربه، ثم سارع بالأوبة والاستغفار: ( إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَاد، فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاق) [ص: 31-33)
وهكذا حال المؤمنين السائرين إلى ربهم في سفينة الحياة، كلما شغلتهم الدنيا بأمر من أمورها الصارفة عن ذكر الله سارعوا بالأوبة إلى الله، فالداعية سريع الأوبة إلى مولاه مع كل كبوة تلقاه .
نبي الله أيوب الصابر الأواب:
أثنى المولى عز وجل عليه بأسلوب المدح والثناء بقوله (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب ) فالعبودية الحقة جعلته عبدا أوابا، وذلك نتيجة صبره وثباته على البلاء ( إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب}.
وقد مدح الله نبيين بهذا الوصف (نعم العبد إنه أواب ) هما سليمان وأيوب عليهما السلام ،
فالأول نبي شاكرعلى ما آتاه الله من الملك والسلطان، والآخر نبي صابر على البلاء والإيمان. وهما أنموذجان عظيمان للمؤمنين الشاكر والصابر .
وكذلك حال المربين والدعاة إلى الله ينبغي تربية الناس على التعلق بالله في حالتي السراء والضراء، ففي الضراء المؤمن أواب صابر، وفي السراء هو أواب شاكر.
المؤمن الأواب
وقد وصف الله عباده المؤمنين الصالحين بالأوابين فقال: {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا}[الإسراء: 25]
وبشر الأوابين بالمغفرة العظيمة، إذ قابل صفة الامتلاء بالأوبة بالامتلاء بالمغفرة التي تغمرهم وتحتويهم فتشملهم على كثرة ذنوبهم، فمن آب إلى الله من ذنبه ورجع إليه تكررت المغفرة له مع كل أوبة .
وكذلك جعل دخول الجنة جزاء لكل أواب حفيظ، ( هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظ) [ق: 32]
حفيظ لكل ما قربه إلى ربه من الفرائض والطاعات والذنوب التي سلفت منه؛ للتوبة منها والاستغفار.
ويتصف هذا الأواب الحفيظ بأنه كثير الخشية لربه، ( مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيب) [ق: 33] نسأل الله تعالى الهداية وأن يجعلنا من الأوابين المنيبين إليه .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

(رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً )٢٥-الإسراء
إن المؤمن منطقيّ مع نفسه؛ لأنه آمن بقلبه ولسانه، وأن الكافر كذلك منطقيّ لأنه كفر بقلبه ولسانه، أما المنافق فغير منطقيّ مع نفسه؛ لأنه آمن بلسانه وجحد بقلبه.
وهذه الآية تدعونا إلى الحديث عن النفاق؛ لأنه ظاهرة من الظواهر المصاحبة للإيمان بالله، وكما نعلم فإن النفاق لم يظهر في مكة التي صادمتْ الإسلام وعاندته، وضيقتْ عليه، بل ظهر في المدينة التي احتضنتْ الدين، وانساحت به في شتى بقاع الأرض، وقد يتساءل البعض: كيف ذلك؟
نقول: النفاق ظاهرة صحية إلى جانب الإيمان؛ لأنه لا يُنافَق إلا القوي، والإسلام في مكة كان ضعيفاً، فكان الكفار يُجابهونه ولا ينافقونه، فلما تحوّل إلى المدينة اشتد عوده، وقويتْ شوكته وبدأ ضِعَاف النفوس ينافقون المؤمنين.
لذلك يقول أحدهم: كيف وقد ذَمَّ الله أهل المدينة، وقال عنهم: { وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ .. } [التوبة: 101].
نقول: لقد مدح القرآن أهل المدينة بما لا مزيدَ عليه، فقال تعالى في حقهم: { وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُوا ٱلدَّارَ وَٱلإِيمَانَ .. } [الحشر: 9].
وكأنه جعل الإيمان مَحَلاً للنازلين فيه. { يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .. } [الحشر: 9].
فإنْ قال بعد ذلك: { وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ .. } [التوبة: 101].
فالنفاق في المدينة ظاهرة صحية للإيمان؛ لأن الإيمان لو لم يكن قوياً في المدينة لما نافقه المنافقون.
ومن هنا جعل الله المنافقين في الدرْكِ الأسفل من النار، لأنه مُندَسٌّ بين المؤمنين كواحد منهم، يعايشهم ويعرف أسرارهم، ولا يستطيعون الاحتياط له، فهو عدو من الداخل يصعُب تمييزه. على خلاف الكافر، فعداوته واضحة ظاهرة معلنة، فيمكن الاحتياط له وأخذ الحذر منه.
ولكن لماذا الحديث عن النفاق ونحن بصدد الحديث عن عبادة الله وحده وبِرِّ الوالدين؟
الحق سبحانه وتعالى أراد أنْ يُعطينا إشارة دقيقة إلى أن النفاق كما يكون في الإيمان بالله، يكون كذلك في برِّ الوالدين، فنرى من الأبناء مَنْ يبرّ أبويْه نفاقاً وسُمْعة ورياءً، لا إخلاصاً لهما، أو اعترافاً بفضلهما، أو حِرْصاً عليهما.
ولهؤلاء يقول تعالى: { رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ .. } [الإسراء: 25].
لأن من الأبناء مَنْ يبرّ أبويه، وهو يدعو الله في نفسه أنْ يُريحه منهما، فجاء الخطاب بصيغة الجمع: { رَّبُّكُمْ } أي: رب الابن، وربّ الأبوين؛ لأن مصلحتكم عندي سواء، وكما ندافع عن الأب ندافع أيضاً عن الابن، حتى لا يقعَ فيما لا تُحمد عُقباه.
وقوله: { إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ .. } [الإسراء: 25].
أيْ: إن توفّر فيكم شَرْط الصلاح، فسوف يُجازيكم عليه الجزاء الأوفى. وإنْ كان غَيْر ذلك وكنتم في أنفسكم غير صالحين غَيْر مخلصين، فارجعوا من قريب، ولا تستمروا في عدم الصلاح، بل عودوا إلى الله وتوبوا إليه.
{ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً } [الإسراء: 25].
والأوابون هم الذين اعترفوا بذنوبهم ورجعوا تائبين إلى ربهم.
وقد سبق أنْ أوضحنا أن مشروعية التوبة من الله للمذنبين رحمةٌ من الخالق بالخلق؛ لأن العبد إذا ارتكب سيئة في غفلة من دينه أو ضميره، ولم تشرع لها توبة لوجدنا هذه السيئة الواحدة تطارده، ويشقى بها طِوَال حياته، بل وتدعوه إلى سيئة أخرى، وهكذا يشقى به المجتمع.
لذلك شرع الخالقُ سبحانه التوبة ليحفظ سلامة المجتمع وأَمْنه، وليُثرِي جوانب الخير فيه.

- ﴿رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾ ﴾ [الإسراء آية:٢٥]
﴿رَّبُّكم أَعلَمُ بمَا في نُفوسكُمْ﴾ يعلم ما تضمرون.. ويفهم رغباتكم..! فلن يضيع خيرًا نويته، وحيل بينك وبينه، فلكل امرئ ما نوى
﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ قال سعيد بن المسيب : هو الذي يذنب ثم يتوب ، ثم يذنب ثم يتوب
(فإنه كان للأوابين غفورا) من علم الله أنه ليس في قلبه إلا الإنابة إليه ومحبته فإن الله يعفو عنه الأمور العارضة مماهومن مقتضى الطبائع البشرية
﴿ربكم أعلم بما في نفوسكم ﴾ إن تألمتَ لقولٍ ليس فيك ، فيكفيك عِلْمُ الله بما فيك
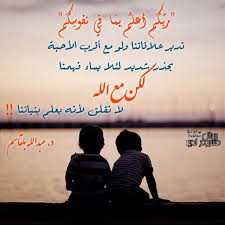
تأملات قرآنية ودلالات تربوية في كلمة (أوَّاب)
ن المتأمل في بديع وصف القرآن، وإيحاءاته التربوية في بناء النفس والحياة؛ يستوقفه روعة الأسلوب القرآني في ذلك، إذ يأتلف الأسلوب البليغ مع الإيحاء التربوي البديع، وهذا من خصائصه الفريدة، التي يتفرد بها البيان القرآني دون غيره من سائر البيان.
وفي هذا المقال نتناول دلالة كلمة (أواب) وإيحاءاتها التربوية في سياقات البيان القرآني المختلفة؛ ليتصف بها الدعاة والمربون في واقع الدعوة والحياة.
أولا- أوَّاب ( الاشتقاق اللغوي ودلالة الإيحاء )
إن كلمة أوَّاب هي صيغة مبالغة من الفعل آب فهو أوَّاب ، بمعنى راجع ، أي: كثير الأوبة والتوبة والرجوع إلى ربه ، وكل صيغ المبالغة هي في القرآن تفيد الكثرة البالغة والامتلاء بالوصف .
والبيان القرآني دقيق في اختيار أوّاب من الإياب دون غيرها كالرجوع مثلا ؛ لأن الإياب كما يرى الراغب الأصفهاني يكون من ذوي الإرادات، في حين أن الرجوع يكون منها ومن غيرها، فإننا نقول رجع المطر ، ورجع الحجر على صاحبه مثلا، ولا نقول في هذا المقام آب، فالجمادات لا يصدق عليها ذلك إذ لا إرادة لها.
ومن معانيه أيضا السير في النهار، فالتأويب هو السير في النهار،ومن معانيه أيضا السرعة، فناقة أواب، أي: سريعة، ومن معانيه السياقية أيضا التسبيح ومنه قوله تعالى عن نبيه داود (يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيد) [سبأ: 10] فالتأويب هنا هو التسبيح بدليل التصريح به في موضع آخر في وصف نبيه داود في قوله تعالى {إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاق}[ص: 18]، والتسبيح ضرب من ضروب التنزيه والتقديس والتعظيم لله عز وجل.
وتوحي صيغة أوَّاب (فعَّال) بالكثرة والقوة أيضا، أي: كثرة الرجوع وقوته ،فهو رجوع متكرروبقوة، مقرون برغبة وإرادة واعية مدركة .
ومن هنا يمكننا فهم دلالات إيحاء الصيغة في هذا المقام، بأن المؤمن بربه المحب له أوَّاب إليه،أي: كثير الرجوع إلى طاعته كلما شرد أو ابتعد أو ضعف في هذه الحياة، بموجب مركب النقص البشري فيه، تذكر فسارع بالرجوع إلى الطاعة والتوبة والأوبة. على سبيل الهيبة والتعظيم لربه، و بدافعية ذاتية، وبقوة وسرعة، وإرادة واعية ، كمن يسير في ضوء النهار، فهي أوبة ذاتية سريعة مشوبة بالتعظيم ، و متكررة بقوة وبوعي .
ثانيا :- مقامات (أوَّاب) في القرآن
وردت هذه الصفة في سياق المدح لثلاثة أنبياء في القرآن الكريم هم : داود وسليمان وأيوب عليهم السلام، وكذلك وردت عموما في وصف المؤمنين .
ولنا أن نتأمل هذه المقامات في سياقاتها المختلفة ؛ لاستخراج الفوائد والعبر من ذلك؛ للتحلي بهذه الصفة في حياة المؤمنين الدعاة .
نبي الله داود قوة الإيمان والسلطان.
ورد وصفه بهذه الصفة في قوله تعالى : {اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّاب}[ص: 17]
فجاء ذلك في سياق التثبيت بالصبر للنبي محمد ﷺ أن يتأسى بنبي الله داود، فقد وصفه الله بالعبودية والقوة وأنه أواب، فترتب على عبوديته وقوة إيمانه أن تأكد فيه وصف أواب أي: كثير الرجوع والإنابة والتوبة إلى ربه، فعلى المربين والدعاة المؤمنين التحلي بهذا الوصف ليستطيعوا الصبر والتحمل لمشاق الدعوة التي هي رسالة الأنبياء عليهم السلام، فلن يستطيعوا الصبر مالم تتحقق فيهم العبودية لله وقوة الإيمان التي تؤهلهم لأن يكونوا أوابين لله مخبتين له .
ونبي الله داود آتاه الله الملك ولم يشغله ذلك أو يصرفه عن الإنابة إليه، فهذا أنموذج إيماني رفيع في الجمع بين الملك والعبودية والإنابة.
فعلى الدعاة إلى الله الإمساك بزمام المبادرة في قيادة الحياة، ولا يصرفهم ذلك أو يشغلهم عن الله، إنما هم قادة أوَّابون إليه ، يستمدون العون منه والتوفيق والقوة والثبات.
نبي الله سليمان، الشاكر الأواب:
وقد مدحه الله عز وجل بالعبودية الحقة وأنه أواب ، فقال : { وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب} [ص: 30] وعلل وصفه إياه بأواب؛ أنه ابتلي بأمر من أمور الدنيا شغله عن ذكر ربه، ثم سارع بالأوبة والاستغفار: ( إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَاد، فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاق) [ص: 31-33)
وهكذا حال المؤمنين السائرين إلى ربهم في سفينة الحياة، كلما شغلتهم الدنيا بأمر من أمورها الصارفة عن ذكر الله سارعوا بالأوبة إلى الله، فالداعية سريع الأوبة إلى مولاه مع كل كبوة تلقاه .
نبي الله أيوب الصابر الأواب:
أثنى المولى عز وجل عليه بأسلوب المدح والثناء بقوله (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب ) فالعبودية الحقة جعلته عبدا أوابا، وذلك نتيجة صبره وثباته على البلاء ( إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب}.
وقد مدح الله نبيين بهذا الوصف (نعم العبد إنه أواب ) هما سليمان وأيوب عليهما السلام ،
فالأول نبي شاكرعلى ما آتاه الله من الملك والسلطان، والآخر نبي صابر على البلاء والإيمان. وهما أنموذجان عظيمان للمؤمنين الشاكر والصابر .
وكذلك حال المربين والدعاة إلى الله ينبغي تربية الناس على التعلق بالله في حالتي السراء والضراء، ففي الضراء المؤمن أواب صابر، وفي السراء هو أواب شاكر.
المؤمن الأواب
وقد وصف الله عباده المؤمنين الصالحين بالأوابين فقال: {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا}[الإسراء: 25]
وبشر الأوابين بالمغفرة العظيمة، إذ قابل صفة الامتلاء بالأوبة بالامتلاء بالمغفرة التي تغمرهم وتحتويهم فتشملهم على كثرة ذنوبهم، فمن آب إلى الله من ذنبه ورجع إليه تكررت المغفرة له مع كل أوبة .
وكذلك جعل دخول الجنة جزاء لكل أواب حفيظ، ( هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظ) [ق: 32]
حفيظ لكل ما قربه إلى ربه من الفرائض والطاعات والذنوب التي سلفت منه؛ للتوبة منها والاستغفار.
ويتصف هذا الأواب الحفيظ بأنه كثير الخشية لربه، ( مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيب) [ق: 33] نسأل الله تعالى الهداية وأن يجعلنا من الأوابين المنيبين إليه .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.


تعليق