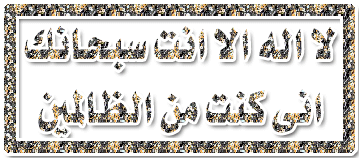إالصدق مع الله
أصل الحياة الطيبة، وقاعدة السعادة المنشودة، وأساس العاقبة الحسنة في العاجل والآجل يكمُن في الصدق مع الله - جل وعلا - ظاهرًا وباطنًا، قولًا وفعلًا، طاعةً وامتثالًا؛ فعلى هذا المُرتَكَز تتحقَّق الثمار الطيبة والنتائج المرضية دنيا وأخرى، يقول ربنا - جل وعلا -: {فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ} [محمد: 21 ].
أعطى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أعرابيًّا قسمًا من غنائم خيبر، فجاء للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما على هذا اتبعتُك يا رسول الله، ولكن اتبعتُك على أن أُرمَى ها هنا - وأشار إلى حلقه - فأموت فأدخل الجنة، فقال: «إنْ تصدقِ الله يصدُقك»، ثم نهض إلى قتال العدو، فأُتيَ به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مقتول، فقال: «أهو هو؟». فقالوا: نعم، فقال: «صدق اللهَ فصدَقَه»؛ فكفَّنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في جُبَّته، ثم دعا له: «الَّلهُمَّ هذا عبدُك خرجَ مهاجِرًا في سبيلِك قُتِلَ شهِيدًا، وأنا على ذلك شهِيد»؛ والحديث إسناده صحيح.
إنه الصدقُ الذي يعيش به القلب والبدن، والظاهر والباطن في رعاية تامة لأوامر الله - جل وعلا -، والاستقامة على منهجه - سبحانه -، إنها تربية الباطن باليَقَظَة الدائمة والحذر التام من الجبار - جل وعلا - ومن سخطه وأليم عقابه، والسعي إلى رضوانه وجنته: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ} [آل عمران: 30 ].
ولهذا فالأمة المسلمة اليوم وهي تُحيطُ بها الفتن من كل جانب، وتعلو حياتَها المصائبُ من كل حدبٍ في أمسِّ الحاجة للصدق مع الله - جل وعلا - صدق الإيمان والطاعة، صدق التوجه والإرادة، صدق العمل والاتباع في كل شأن، وفي جميع مجالات الحياة.
إن هذا الأصل هو المُقوِّم لعمل الأفراد والمجتمعات نحو الإصلاح والفلاح والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، وهو الذي يقودُها إلى الظَّفَر بالمطلوب، والنجاة من المرهوب.
ولهذا فالحاكم في حاجةٍ للصدق مع الله - جل وعلا - في سياسة الرعية، ومراعاة مصالحهم، والقيام على تحقيق شئونهم، وكذلك الرعية في حاجةٍ إلى الصدق مع الله - جل وعلا - في طاعة الحاكم على المنهج الإسلامي الذي جاء به الشرع المُطهَّر لتحقيق مجتمعٍ فاضلٍ تتحقَّق فيه الحياة الطيبة والعيشة الرضية.
وهكذا كل مسئول لا يستقيم منهجه ولا يصلح عمله ولا يُفلِح سعيُهُ إلا إذا صَدَقَ مع الله - جل وعلا - وصَدَقَ في المنهج الشرعي الذي تقوم عليه أصول مسئوليته، وكان ابتغاء رضوان الله ونيل ما عنده الباعثَ له في كل تصرُّفاته؛ فالقاضي لا يُوفَّق إلى الصواب إلا بصدقٍ تامٍّ مع الله - جل وعلا -، والمُفتِي لا يهتدي إلى ما فيه براءة ذِمَّته إلا إذا كان صادقًا مع الله ظاهرًا وباطنًا، وهكذا التاجر في تجارته، والعامل في صنعته، والكاتب في كتابته، والإعلامي في إعلامه.
معاشر المسلمين:
إن الصدق مع الله - جل وعلا - تظهر حقيقتُه في الخوف من الله باطنًا وظاهرًا؛ فتكون الحركات والسكنات والتصرُّفات والتوجُّهات والإرادات والأعمال والأقوال كلها محكومةً بأمر الله - سبحانه - وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، مُحاطةً بسِياج المنهج القرآني والهدي النبوي، مُراد بها وجه الله، لا تُخالِطُها أهواء نفسية، ولا تُخالِجها مصالح شخصية، ولا تحكمها نزعاتٌ دنيوية، ولا توجُّهات شخصية؛ بل الحَكَمُ في المنشَط والمكره، والمرجعُ في العُسْر واليُسْر، والمردُّ في الرخاء والشدة: تحقيقُ شرع الله وامتثالُ أمره، وسواءٌ كان ذلك مع الصديق، أو مع العدو، أو مع القريب والبعيد، أو مع الغني والفقير.
يقول الصِّدِّيق: «لا خيرَ في قولٍ لا يريد به صاحبُهُ وجهَ الله»، ويقول خالد بن الوليد - رضي الله عنه -: «رَحِمَ الله عمرَ إن أقواله وأفعاله كلها مرادٌ بها وجه الله».
إنه الصدق الذي تضمحِلُّ معه حظوظ النفوس ومُشتهياتُها؛ ففي قصة (سقيفة بني سعد) بعد أن اختار أبو بكرٍ عمرَ وأبا عبيدة ليبايَعا قال عمر: «والله ما كرهتُ من قوله إلا ذلك»، ثم قال: «والله لَأَنْ أُقَدَّم فأضرب فيُضرَب عنقي لا يُقرِّبني ذلك من إثمٍ أَحَبُّ إليَّ من أن أتأمَّرَ على قومٍ فيهم أبو بكر»، ثم قال: «اُبسُطْ يدَكَ»، فبايَعَه ثم بايَعَه المهاجرون والأنصار.
إنه الصدق الذي حَدَا بعليٍّ - رضي الله عنه - حينما قال أبو بكرٍ في أثناء البيعة وطلب الاعتذار قال له عليٌّ: «والله لا نقيلُك ولا نستقيلُك؛ قدَّمَك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فمن ذا يُؤخِّرك؟».
إنه الصدق الذي حَدَا بالأنصار أن يقولوا: نعوذ بالله أن نتقدَّم أبا بكرٍ، قدَّمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ديننا؛ أي: في الصلاة.
معاشر المسلمين:
وما أروع ما ضربه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نماذجَ رائعة في الصدق مع البارئ - سبحانه - بفضل التربية النبوية والمدرسة المحمدية.
ذكر ابن حجر - رحمه الله - في كتابه «الإصابة» أن «سعد بن خيثمة استَهَمَ هو وأبوه يوم بدر فخرج سهمُ سعد، فقال له أبوه: يا بنيّ! آثِرني اليوم، فقال سعد: يا أبتِ لو كان غير الجنة فعلتُ، فخرج سعدٌ إلى بدر وبقي أبوه، فقُتِل بها سعد وقُتِل أبوه بعد ذلك خيثمة يوم أحد». كل ذلك بسبب الصدق مع الله - جل وعلا -، فنالُوا الشهادة التي هي أعظم مطلوب.
وفي صحيح السيرة: أن عُمَير بن أبي وقاص رُدَّ يوم بدر لصغره، فبكى؛ فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال سعد أخوه: «رأيتُ أخي عُميرًا قبل أن يعرضنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر يتوارَى حتى لا يراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ما لَكَ يا أخي؟ فقال: إني أخاف أن يراني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيستصغرني ويرُدَّني وأنا أحب الخروج لعل الله أن يرزقني الشهادة، فصَدَقَ وصَدَقَه الله وأعلى درجاته بالشهادة في سبيله».
وفي صحيح السيرة أيضًا: أن أنس بن النضر - رضي الله عنه - كان يأسف أسفًا شديدًا لعدم شهوده بدرًا، فقال: والله لَئِنْ أراني الله مشهدًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليريَنَّ الله ما كيف أصنع، وصَدَقَ في وعده مع الله، فلما كان يوم أُحُد مرَّ على قوم أذهَلَتهم شائعةُ موت النبي - صلى الله عليه وسلم - وألقَوا بسلاحهم، فقال: ما يُجلِسُكم؟ قالوا: قُتِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا قوم! إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قُتِل، فإن ربَّ محمدٍ حيٌّ لا يموت، وموتوا على ما مات عليه رسول الله، وقال: «اللهم إني أعتذِرُ إليك مما قال هؤلاء»، ثم لقِيَ سعد بن معاذ فقال: يا سعد! إني لَأجِد ريحَ الجنة دون أُحُد، ثم ألقى بنفسه في صفِّ المشركين وما زال يُقاتِل حتى استُشهِد؛ فوُجِد فيه بضعٌ وثمانون ما بين ضربةٍ بسيف، أو طعنةٍ برمح، أو رميةٍ بسهم، فلم تعرفه إلا أختُه ببَنَانِه، وفي أمثاله نزل قوله - سبحانه -: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 23 ].
والأمثلةُ والنماذجُ الرائعة في صدقهم مع الله - جل وعلا - أكثر من أن تُحصَر؛ مما بوَّأَهم المكانة الساميَّة، والمنزلة الرفيعة حتى قال الله فيهم: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 100 ].
فما أحوجَنا - معاشر المسلمين - إلى أن نصدُق مع الله قولًا وفعلًا، ظاهرًا وباطنًا، قصدًا وإرادةً، وأن نُسَيِّر حياتنا ومناهجنا وتصرُّفاتنا على هذا المنهج المُرتَضى؛ لنَبُوء بالمغفرة والرضوان في الآخرة، وبالسعادة والحياة الطيبة في هذه الداروالحمد لله رب العالمين وصلى الله سيدنا محمدوعلى اله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم اغفر لي وللمؤمنين وللمؤمنات الاحياء والاموات
أصل الحياة الطيبة، وقاعدة السعادة المنشودة، وأساس العاقبة الحسنة في العاجل والآجل يكمُن في الصدق مع الله - جل وعلا - ظاهرًا وباطنًا، قولًا وفعلًا، طاعةً وامتثالًا؛ فعلى هذا المُرتَكَز تتحقَّق الثمار الطيبة والنتائج المرضية دنيا وأخرى، يقول ربنا - جل وعلا -: {فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ} [محمد: 21 ].
أعطى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أعرابيًّا قسمًا من غنائم خيبر، فجاء للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما على هذا اتبعتُك يا رسول الله، ولكن اتبعتُك على أن أُرمَى ها هنا - وأشار إلى حلقه - فأموت فأدخل الجنة، فقال: «إنْ تصدقِ الله يصدُقك»، ثم نهض إلى قتال العدو، فأُتيَ به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مقتول، فقال: «أهو هو؟». فقالوا: نعم، فقال: «صدق اللهَ فصدَقَه»؛ فكفَّنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في جُبَّته، ثم دعا له: «الَّلهُمَّ هذا عبدُك خرجَ مهاجِرًا في سبيلِك قُتِلَ شهِيدًا، وأنا على ذلك شهِيد»؛ والحديث إسناده صحيح.
إنه الصدقُ الذي يعيش به القلب والبدن، والظاهر والباطن في رعاية تامة لأوامر الله - جل وعلا -، والاستقامة على منهجه - سبحانه -، إنها تربية الباطن باليَقَظَة الدائمة والحذر التام من الجبار - جل وعلا - ومن سخطه وأليم عقابه، والسعي إلى رضوانه وجنته: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ} [آل عمران: 30 ].
ولهذا فالأمة المسلمة اليوم وهي تُحيطُ بها الفتن من كل جانب، وتعلو حياتَها المصائبُ من كل حدبٍ في أمسِّ الحاجة للصدق مع الله - جل وعلا - صدق الإيمان والطاعة، صدق التوجه والإرادة، صدق العمل والاتباع في كل شأن، وفي جميع مجالات الحياة.
إن هذا الأصل هو المُقوِّم لعمل الأفراد والمجتمعات نحو الإصلاح والفلاح والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، وهو الذي يقودُها إلى الظَّفَر بالمطلوب، والنجاة من المرهوب.
ولهذا فالحاكم في حاجةٍ للصدق مع الله - جل وعلا - في سياسة الرعية، ومراعاة مصالحهم، والقيام على تحقيق شئونهم، وكذلك الرعية في حاجةٍ إلى الصدق مع الله - جل وعلا - في طاعة الحاكم على المنهج الإسلامي الذي جاء به الشرع المُطهَّر لتحقيق مجتمعٍ فاضلٍ تتحقَّق فيه الحياة الطيبة والعيشة الرضية.
وهكذا كل مسئول لا يستقيم منهجه ولا يصلح عمله ولا يُفلِح سعيُهُ إلا إذا صَدَقَ مع الله - جل وعلا - وصَدَقَ في المنهج الشرعي الذي تقوم عليه أصول مسئوليته، وكان ابتغاء رضوان الله ونيل ما عنده الباعثَ له في كل تصرُّفاته؛ فالقاضي لا يُوفَّق إلى الصواب إلا بصدقٍ تامٍّ مع الله - جل وعلا -، والمُفتِي لا يهتدي إلى ما فيه براءة ذِمَّته إلا إذا كان صادقًا مع الله ظاهرًا وباطنًا، وهكذا التاجر في تجارته، والعامل في صنعته، والكاتب في كتابته، والإعلامي في إعلامه.
معاشر المسلمين:
إن الصدق مع الله - جل وعلا - تظهر حقيقتُه في الخوف من الله باطنًا وظاهرًا؛ فتكون الحركات والسكنات والتصرُّفات والتوجُّهات والإرادات والأعمال والأقوال كلها محكومةً بأمر الله - سبحانه - وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، مُحاطةً بسِياج المنهج القرآني والهدي النبوي، مُراد بها وجه الله، لا تُخالِطُها أهواء نفسية، ولا تُخالِجها مصالح شخصية، ولا تحكمها نزعاتٌ دنيوية، ولا توجُّهات شخصية؛ بل الحَكَمُ في المنشَط والمكره، والمرجعُ في العُسْر واليُسْر، والمردُّ في الرخاء والشدة: تحقيقُ شرع الله وامتثالُ أمره، وسواءٌ كان ذلك مع الصديق، أو مع العدو، أو مع القريب والبعيد، أو مع الغني والفقير.
يقول الصِّدِّيق: «لا خيرَ في قولٍ لا يريد به صاحبُهُ وجهَ الله»، ويقول خالد بن الوليد - رضي الله عنه -: «رَحِمَ الله عمرَ إن أقواله وأفعاله كلها مرادٌ بها وجه الله».
إنه الصدق الذي تضمحِلُّ معه حظوظ النفوس ومُشتهياتُها؛ ففي قصة (سقيفة بني سعد) بعد أن اختار أبو بكرٍ عمرَ وأبا عبيدة ليبايَعا قال عمر: «والله ما كرهتُ من قوله إلا ذلك»، ثم قال: «والله لَأَنْ أُقَدَّم فأضرب فيُضرَب عنقي لا يُقرِّبني ذلك من إثمٍ أَحَبُّ إليَّ من أن أتأمَّرَ على قومٍ فيهم أبو بكر»، ثم قال: «اُبسُطْ يدَكَ»، فبايَعَه ثم بايَعَه المهاجرون والأنصار.
إنه الصدق الذي حَدَا بعليٍّ - رضي الله عنه - حينما قال أبو بكرٍ في أثناء البيعة وطلب الاعتذار قال له عليٌّ: «والله لا نقيلُك ولا نستقيلُك؛ قدَّمَك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فمن ذا يُؤخِّرك؟».
إنه الصدق الذي حَدَا بالأنصار أن يقولوا: نعوذ بالله أن نتقدَّم أبا بكرٍ، قدَّمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ديننا؛ أي: في الصلاة.
معاشر المسلمين:
وما أروع ما ضربه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نماذجَ رائعة في الصدق مع البارئ - سبحانه - بفضل التربية النبوية والمدرسة المحمدية.
ذكر ابن حجر - رحمه الله - في كتابه «الإصابة» أن «سعد بن خيثمة استَهَمَ هو وأبوه يوم بدر فخرج سهمُ سعد، فقال له أبوه: يا بنيّ! آثِرني اليوم، فقال سعد: يا أبتِ لو كان غير الجنة فعلتُ، فخرج سعدٌ إلى بدر وبقي أبوه، فقُتِل بها سعد وقُتِل أبوه بعد ذلك خيثمة يوم أحد». كل ذلك بسبب الصدق مع الله - جل وعلا -، فنالُوا الشهادة التي هي أعظم مطلوب.
وفي صحيح السيرة: أن عُمَير بن أبي وقاص رُدَّ يوم بدر لصغره، فبكى؛ فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال سعد أخوه: «رأيتُ أخي عُميرًا قبل أن يعرضنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر يتوارَى حتى لا يراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ما لَكَ يا أخي؟ فقال: إني أخاف أن يراني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيستصغرني ويرُدَّني وأنا أحب الخروج لعل الله أن يرزقني الشهادة، فصَدَقَ وصَدَقَه الله وأعلى درجاته بالشهادة في سبيله».
وفي صحيح السيرة أيضًا: أن أنس بن النضر - رضي الله عنه - كان يأسف أسفًا شديدًا لعدم شهوده بدرًا، فقال: والله لَئِنْ أراني الله مشهدًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليريَنَّ الله ما كيف أصنع، وصَدَقَ في وعده مع الله، فلما كان يوم أُحُد مرَّ على قوم أذهَلَتهم شائعةُ موت النبي - صلى الله عليه وسلم - وألقَوا بسلاحهم، فقال: ما يُجلِسُكم؟ قالوا: قُتِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا قوم! إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قُتِل، فإن ربَّ محمدٍ حيٌّ لا يموت، وموتوا على ما مات عليه رسول الله، وقال: «اللهم إني أعتذِرُ إليك مما قال هؤلاء»، ثم لقِيَ سعد بن معاذ فقال: يا سعد! إني لَأجِد ريحَ الجنة دون أُحُد، ثم ألقى بنفسه في صفِّ المشركين وما زال يُقاتِل حتى استُشهِد؛ فوُجِد فيه بضعٌ وثمانون ما بين ضربةٍ بسيف، أو طعنةٍ برمح، أو رميةٍ بسهم، فلم تعرفه إلا أختُه ببَنَانِه، وفي أمثاله نزل قوله - سبحانه -: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 23 ].
والأمثلةُ والنماذجُ الرائعة في صدقهم مع الله - جل وعلا - أكثر من أن تُحصَر؛ مما بوَّأَهم المكانة الساميَّة، والمنزلة الرفيعة حتى قال الله فيهم: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 100 ].
فما أحوجَنا - معاشر المسلمين - إلى أن نصدُق مع الله قولًا وفعلًا، ظاهرًا وباطنًا، قصدًا وإرادةً، وأن نُسَيِّر حياتنا ومناهجنا وتصرُّفاتنا على هذا المنهج المُرتَضى؛ لنَبُوء بالمغفرة والرضوان في الآخرة، وبالسعادة والحياة الطيبة في هذه الداروالحمد لله رب العالمين وصلى الله سيدنا محمدوعلى اله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم اغفر لي وللمؤمنين وللمؤمنات الاحياء والاموات